علي نوار
كاتب ومترجم مصري
تعرف أي فوبيا أو رهاب اجتماعي، كما يمكن الفهم، بأنها موقف يمس كرامة الأشخاص، لأنها لا تقيمهم على أساس ماهيتهم، بل تصدر أحكاما مسبقة، وتنسب إليهم مسؤولية أمور عدة بسبب تشاركهم في بعض الخواص التي لا علاقة لها بشخصياتهم.
يعد رهاب الإسلام انعكاساً لرهاب المسيحية الذي يمارسه “الإرهابيون الإسلاميون” الذين يرون في “المسيحي الغربي” تجسيدا منطبقاً للشر، وهذا بالطبع غير عقلاني أيضاً. يكون من الصعب بالتأكيد علينا نحن الغربيين فهم التعميم الظالم واتهامنا جميعا بالمسؤولية عن كل الشرور التي يعاني منها المسلمون في أماكن أخرى.
البعض لا يعتقد قطعاً أنه من المجحف التعميم واتهام كل المسلمين بالطريقة نفسها بمسؤوليتهم عن العنف الجهادي.
لكن معاداة الأجانب لا تزال حاضرة بقوة بين الناس بسبب “الخوف من الآخر” والمختلف والمجهول، إنه عامل متجذر لدى البشر يمكن تجاوزه فقط بجرعات مكثفة من العقلانية والتعاطف.
وليس المشهد العالمي في الوقت الحالي هو الأمثل لعكس معاداة الأجانب، بل يبدو أنه على العكس، إذ يؤدي، مع الأسف، لزيادتها بشكل مقلق. تتكفل وسائل الإعلام بتعزيزها عبر خطاب الكراهية بأكثر طريقة ممكنة تفتقر للمسؤولية.
على أنّ التأكيد الأخطر يبدو أنه “الإسلام هو المشكلة”.
حينما يجرى تأكيد ذلك ودون أي تأصيل، يكون هناك تأكيد متخبط لا يعي التعقيد الحقيقي للموضوع.
لأنه، ما المغزى من تأكيد ذلك؟ هل الإشارة إلى أنّ الإسلام يحمل في طياته بعض الخصائص التي تجعله غير متوافق مع الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان؟
إنّ البوسنة وألبانيا دول ذات تركيبة سكانية مسلمة.
الوضع ذاته ينطبق على عدد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، مثل أربيجان وقرغيزستان وطاجيكستان. لكنها دول علمانية. كانت تركيا كذلك لوقت طويل رغم أنها تمر حالياً بمرحلة تراجع تبعث على القلق.
إنّ التشديد على أنّ الإسلام كديانة يحمل بالتبعية بداخله الأصولية، وبالتالي يستحيل وصف أي دولة يعتنق أغلب مواطنيها الإسلام بأنها دولة علمانية، لهو تأكيد تفنده مباشرة الأحداث. لقد أظهر أوليفيه كاريه في مقاله (الإسلام العلماني) أنّ النصوص الكبرى للفلسفة الإسلامية السياسية، بعيداً عن إيجاد خلط بين الديني والسياسي، تعكس التميز.
يزعم البعض أن القرآن كتاب يحرض على العنف.
لكن القرآن ليس هو سبب العنف، كما أن الكتاب المقدس ليس كذلك، ولا أي نص مقدس في حد ذاته، بل من يعملون على تأويله، وعلى أساس التأويلات يجدون مبرراً للقتل.
النصوص لا تقتل: من يقتلون هم الأشخاص الذين يستخدمونها كذرائع خاوية لبث الرعب. يحوي القرآن نصوصاً تبدو في ظاهرها أنها تبرر استخدام العنف باسم الدين، لكن هذه النصوص موجودة أيضاً في الكتاب المقدس، ولا يستغلها أغلب المسيحيين حالياً لتبرير الحرب المقدسة.
تكمن مشكلة النصوص الدينية- كافة- في غزارة التشبيهات والأساطير واللغة الرمزية، فضلاً عن أنها خارج سياقها التاريخي المحدد تفقد معناها إذا لم يوضع تفسير وسياق منطقي لها.
لكن تنشأ صعوبات لا يمكن تلافيها عند البحث عن التفسيرات الأكثر دقة، لأنها تعتمد في كثير من الحالات على “ذاتية” المفسر.
ومثل أي نص مقدس آخر، فإنّ القرآن غامض بشكل كاف.
الدافع الذي يمهد الطريق أمام المتشددين من كل جانب للعثور على فقرات محددة في الكتب المقدسة تمثل أساساً لا يمكن التشكيك به لترهاتهم وممراً آمناً لجرائم الكراهية التي يرتكبونها.
لكن القرآن هو الكتاب نفسه الذي يقرأه ويتبعه آلاف الأشخاص الذين لا يقتلون ولا يتفقون مع من يفعلوا ذلك.
يأخذ المسلمون والمسلمات من القرآن ما يعتقدونه مناسباُ، بنفس طريقة تعامل المسيحيين مع الكتاب المقدس، فضلاً عن أن الإسلام دين تعددي ومحدود الكهنوتية تتعايش فيه عدة مدارس تفسير تختلف فيما بينها في جوانب عدة.
تؤكد مقولة فارسية قديمة: “يكمن نظام العلماء في اللانظام”.
لكن لا وجود في المنهج الإسلامي المؤسس ما يبرر أو يحرض على العنف أو الحرب ضد أتباع الديانات الأخرى.
بالتالي لا معنى لأن نبحث في أية ورقة مقدسة أو حاجة جوهرية عن الأسباب المباشرة للعنف الدامي الذي يرتكب باسم الدين الإسلامي.
هذا ليس تفسيراً، بل تفسير زائف.
هل يمكننا القول إن المسيحية “بحد ذاتها” دين يحرض على الكراهية، لأن عدد القتلى على أيدي الكنيسة يقدر بالآلاف على مدار التاريخ؟ كان النازيون الذين أبادوا ملايين اليهود بمعسكرات الاعتقال مسيحيين، كذلك باسم الدين، لأن هدفهم كان القضاء على الشعب المسؤول عن مقتل المسيح.
لقد وصل الأمر بهتلر أن صرح “أنا على يقين بأنني أعمل كممثل لخالقنا بمكافحة اليهود فإنني أنفذ إرادة الرب”.
ننسى أحياناً أنّ أوروبا المسيحية كانت على وشك الاندثار بسبب الحروب الدينية التي ضربت القارة في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
شُنت الحروب الصليبية لنشر المسيحية أيضاً استناداً إلى تصور عسكري صرف.
وفي الوقت الراهن، فإنّ فصول العنف بين الهندوس والمسلمين متكررة في الهند.
اليهودية في تأويلاتها الأكثر تشدداً ليست أقل عنفاً، ويؤكد ذلك دولة (إسرائيل) القائمة على فكرة عرقية مركزية.
حتى البوذيون المسالمون يهمشون ويرتكبون المذابح بحق آخرين، والدليل على ذلك ما تعانيه أقلية الروهينجا التي تعتنق الإسلام في ميانمار.
تجنح وجنحت كل الديانات دائماً حتمياً نحو التطرف.
لكن ما يحدد الفارق بينها هو السياق الاجتماعي والثقافي الذي يحدث فيه.
تؤكد الأديان باستمرار أنها متوافقة مع الأنظمة الاجتماعية التي تدخل فيها.
هي مثل أنظمة حية، تولد وتنمو وتموت، وعلى مدار تطورها تمر بتغيرات عديدة بدءاً من الأصولية وحتى الانفتاح والعكس.
حينما تنزع السطوة السياسية عن دين ما، لا يكون ثمة بديل أمامها سوى تقليص قدراتها العنفية لمحاولة التأقلم على السياق الجديد.
هذا بالضبط ما حدث في أوروبا خلال القرن الثامن عشر بظهور التنوير وانتشار الفكر الديمقراطي العالمي القائم على الحرية والمساواة بين جميع المواطنين.
تطلّب هذا الفكر فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، ونشأت أخلاقيات مدنية جديدة، وجرى تحرير التعليم من قمع المنهج الديني.
وإذا كان أحدهم قد تساءل في القرن السادس عشر على ضوء المشهد الأوربي عما إن كان قادراً على استيعاب الديانة المسيحية بمعايير السلام والاحترام، لاعتبر هذا غير قابل للتصديق.
لكن ومنذ اللحظة ذاتها التي نزعت فيها السلطة من الكنيسة وحرمت من امتيازاتها التي دأبت على جمعها، أجبرت على التحول والاستجابة للاحتياجات والمطالب الجديدة من قبل مفهوم المواطنة والعلمنة، حيث لم يعد الدين يلعب دوراً مهيمناً.
وكان المجلس الثاني للفاتيكان هو نهاية هذه العملية.
قد يحدث الأمر عينه في الدول الإسلامية وباقي أماكن العالم، حيث توجد ديانات أخرى. يعتمد ذلك على عوامل التطور التاريخي والاجتماعي.
إنّ ظروف الحياة في الدول الإسلامية حالياً قد يكون سببها في جانب منها، الجمود الاجتماعي الذي يجلبه الدين نفسه، لكن الانتشار والفورة التي تشهدها الأصولية الدينية تعزى من جانبها لاعتبارات تاريخية أخرى.
فقد شهد القرن العشرون نشوء حركة قوية داخل الإسلام دفعت باتجاه العلمانية والأفكار التنويرية.
فقد لاحق عبد الناصر في مصر، على سبيل المثال، النواة الصلبة للإخوان المسلمين، الذين وصفهم بـ”عقول رجعية” كانوا يريدون العودة لـ”عصور الجهل”.
دافعت هذه الحركة أيضاً عن حرية المرأة وانتقدت إجبارها على ارتداء الحجاب.
كانت القومية العربية أيدولوجية مواتية لتحرير شعوب المغرب العربي والشرق الأوسط واستقت جانباً كبيراً من أفكارها من مبادئ الاشتراكية الهادفة لإحداث تقدم كبير لدولها. لكن هذا السعي من أجل الحرية والتنمية تراجع لأن الولايات المتحدة وأوروبا دأبتا على مكافحته، نظراً لأنها لم تكن تريد دولاً إسلامية متفتحة ومستقلة، بل شعوباً مستضعفة وتابعة كي تستطيع بسهولة مد هيمنتها ما بعد- الاستعمارية.
يفعل القتلة الذين يزرعون القنابل ويطعنون أو يدهسون أشخاصاً بإرادتهم الحرة ودون إجبار من قبل أحد على ذلك.
لذا فإنهم مسؤولون بالكامل عن الأفعال التي يرتكبونها.
لكن هذا لا يعني أنه بوسعنا تحليل الأسباب السياسية والاقتصادية والثقافية للإرهاب الإسلامي كظاهرة اجتماعية، ونظراً لوجود بعد اجتماعي له فإنه يتميز بطبيعة خاصة مقارنة بأغلب التصرفات الفردية.
تتماشى المسؤولية الفردية عن الأفعال مع التفسير السببي للأحداث الاجتماعية.
يقول الفيلسوف المادي ماريو بانجي “تجتذب الجماعات الإرهابية عادة أناساً من أصول مختلفة وهي طريقة للضعفاء لإشباع احتياجات متعددة منها المادي (موارد طبيعية أو مناصب عمل)، والسياسي (النظام الاجتماعي)، والثقافي (الديني على وجه الخصوص). وبالطبع كل حملة ضد الإرهاب تبوء بالفشل لا تفعل شيئاً للتعامل مع الشكاوى الحقيقية، يكون لها مفعول في أفضل الحالات، على المدى القصير وعلى حساب الحريات المدنية.
وبشكل عام، تتطلب المشكلات المنهجية حلولاً منهجية طويلة المدى، وليس إجراءات قطاعية محدودة الرؤية، ينشأ العنف المجتمعي بالأساس من حواجز نحن/هم.
لذا فإن أفضل تناول لهذه المشكلة هو “رفع العوائق”.
لم يخرج الإرهابيون الإسلاميون من اللاشيء. يخرجون من أحياء الضواحي حول المدن الكبرى حيث يشجع الفقر والفشل التعليمي على الجريمة وصعوبة اندماج الشباب في المجتمع.
أو من المساجد الأصولية الممولة من قبل بعض الدول، التي تنشر الفكر السلفي، أو مراكز التجنيد التي يفتتحها تنظيم (داعش).
ومن أين يأتي (داعش)؟ لقد زودت الإدارة الأمريكية نفسها بالسلاح تلك الميليشيات التي تشكل التنظيم بغرض زعزعة استقرار المنطقة.
كان سبب حرب العراق في 2003 هو التدخل الأمريكي بدعم حكومتي بريطانيا وإسبانيا، ما أدى لانهيار الدولة بالكامل وحولها إلى مكان مليء بالحقد والكراهية، البيئة المثالية لبروز الجماعات المتطرفة التي تنقلب الآن على المصالح الغربية.
يعتمد تطور الإسلام في العالم الراهن على العلاقة بين القوى الحاضرة والمستقبلية.
يوجد اليوم قطاع من المسلمين المعتدلين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويعادون الهمجية.
يتبنون الأفكار الأكثر تقدمية في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يعانون في أوساطهم الملاحقة وتوابع الرعب ولديهم بالكاد بصيص أمل لتحقيق تغيير في بلدانهم لأنهم لا يحظون حتى بدعم الدول الغربية.
هؤلاء المسلمون الذين يرغبون في العيش بسلام وحرية، هم أول ضحايا التطرف الإسلامي حيث ينتشر.
لذا فإنهم يفرون من الجحيم في أراضيهم إلى أماكن أكثر أماناً على حيواتهم، ثم يجدون في النهاية عدم التفهم والرفض أيضاً في الدول المضيفة.
لكن سواء أكانت العلاقة بين القوى مواتية أم لا للأوساط المعتدلة المتبنية للتنوير والناقدين لكل دولة إسلامية، سيعتمد الأمر برمته على تحركات دول الغرب، إذا كانوا قادرين على التحرك.
ولا تزال هذه العلاقة حتى الآن، وفقا لما نعلمه، لا تصب في صالح هذه القطاعات على الإطلاق. وستظل كذلك طالما أن السياسة الدولية التي تحركها الولايات المتحدة وحلفاؤها هي الخبل الإجرامي كما هي حالياً.
ما الذي يمكن فعله لمعاكسة الآلية الحالية التي تغذي التطرف الديني والإرهاب المصاحب له؟ سأعدّد فقط بعض الأشياء:
*توجيه دعوة لوقف إطلاق النار على جميع جبهات الاقتتال في سوريا، باستثناء تلك التي يجري القتال فيها ضد (داعش).
*قطع مصادر تمويل وتموين الجماعات الإرهابية.
*القضاء على شبكات التجنيد والتأصيل.
*دعم جهود الأوساط الأكثر تقدمية وتنويراً وديمقراطية في دول العالم الإسلامي.
*سحب كل أنواع الدعم لهذه الحكومات التي تغذي وتمول نشر الأصولية الدينية والإرهاب الجهادي.
*حماية اللاجئين.
*الاستضافة الطوعية للمهاجرين القادمين من الدول العربية ودفع أنشطة اللقاء والتفاهم والتبادل بيننا وبينهم، بهدف عزل الإرهابيين كيلا يشعر أي مهاجر بالعزلة أو تلقيه معاملة غير عادلة، ما قد يخلق لديه ميلاً للانضمام إليهم.
*مكافحة الجهل وعدم المساواة سواء في الدول الإسلامية أو الغربية.
*البحث عن حل عادل يمر عبر التفاوض للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي والضغط على الجانبين للتوصل له.
*السعي نحو صور للطاقة البديلة للبترول تسمح بالحد، بشكل فعال، من اعتماد القوى الغربية على دول العالم العربي، بغية إعادة ترسيم العلاقات بين القوى وتقويض نفوذ الأنظمة الأصولية التي تثري الآن من “الذهب الأسود”.
هذه ضمن إجراءات يمكننا الشروع في اتخاذها اعتباراً من الآن في إطار استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب الجهادي على المدى البعيد. لكنها بالطبع إجراءات من شأنها المساس بمصالح مراكز قوى كبرى لا تريد للوضع الراهن أن يتغير.
مقال لأندريس أويرجو ريبيليون منشور في صحيفة دياريوكولاتينو الإسبانية










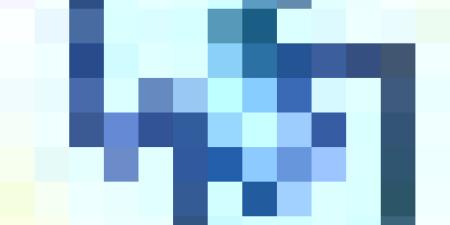


0 تعليق